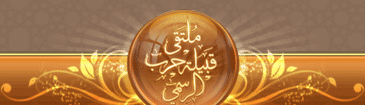بيان معنى قوله تعالى (لم يكد يراها)
قال تعالى: إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا [النور:40] أي: في هذه الظلمات كلها يحاول أن يخرج يده، فيخرجها؛ لأنها تتعلق بقدرته الذهنية، وبقدرته الحركية، ولا تتعلق بالرؤية، ولكن هل يراها أن لا؟
قال ربنا: لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا [النور:40] وتحرير المسألة أن (كاد) عند النحويين فعل من أفعال المقاربة، وأكثر المفسرين يقول: إن معنى (لم يكد يراها) أي: لم يقرب أن يراها، فكيف يراها؟! ولهم في هذا استدلال بأبيات لذي الرمة وغيره.
ولكن الصواب أن يقال: إن (كاد) فعل إذا أثبت دل على النفي، وإذا نفي دل على الإثبات، كما قيل:
أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت على لساني جرهم وثمود
إذا استعملت في صورة النفي أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود
أي: مقام النفي والنكرة، وهذه اللفظة هي الفعل (كاد)، كما قال الله جل وعلا: أَكَادُ أُخْفِيهَا [طه:15]، فالفعل مثبت، وقد أخفاها الله جل وعلا عيناً وقتاً، وقال: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا [محمد:18]، المهدي والدجال وعيسى، طلوع الشمس من مغربها.
فقوله تعالى: لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا [النور:40] معناه -بحسب فهمنا اللغة- أنه يرى شيئاً يسيراً منها، وهذه معضلة، إذ كيف يرى شيئاً يسيراً من النور؟! فهذا هو الذي جعلهم يقولون: إنه لم يقرب أن يراها، فكيف يراها؟! وأظن -والعلم عند الله- أن المقصود بالإظهار البين في النور اليسير من باب إقامة الحجة، أما الذي لا يرى بالكلية -كالمجنون والصغير وأمثالهم- فلا حساب عليه؛ لأنه لم تقم عليه حجة، والعلم عند الله.